التايتل في المجتمعات العربية: قناع أم قيمة؟

سامية عرموش
كتبت: سامية عرموش
بدايةً، أود التوضيح أنني لا أقدم هنا تعميمًا قاطعًا، ولا أسعى لإبراز مجتمع على حساب آخر، وإنما أهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة معينة بهدف فهمها والمساهمة في تصحيح مسارها.
===
كان لي زميل عربي في إحدى المناسبات، ما زلت أتذكر انزعاجه الشديد الذي وصل حد الاستشاطة، لمجرد أننا لم ننعته بـ "الدكتور" قبل ذكر اسمه. هذا الموقف، وإن بدا فرديًا، إلا أنه يحمل في طياته دلالة عميقة على ظاهرة مجتمعية واسعة: التقديس المبالغ فيه للألقاب والمسميات الوظيفية (التايتل) في عالمنا العربي. على النقيض تمامًا، أذكر أساتذتي اليهود في الجامعة، الذين حملوا أرفع الألقاب العلمية كالدكتوراه والأستاذية، لكنهم كانوا يفضلون أن يُخاطَبوا بأسمائهم الأولى، وببساطة تعكس جوهر العلم والتواضع. هذا التباين اللافت يدفع للتساؤل: لماذا تُمنح هذه الألقاب كل هذا الثقل الاجتماعي في مجتمعاتنا؟ ولماذا يصل الأمر ببعض الأفراد إلى هذا الحد من الانزعاج إذا لم يُذكر لقبهم؟ بل إن الأمر يتجاوز الأفراد ليصبح ظاهرة، فلقد عرفتُ عددًا من الأشخاص الذين أصبحوا بين عشية وضحاها حاملين للقب "الدكتوراه"، في ظاهرة تشير بوضوح إلى أن الهدف قد لا يكون دائمًا التطور الفكري أو المساهمة المعرفية الأصيلة، بقدر ما هو حاجة ملحة لحمل لقب يمنح صاحبه مكانة اجتماعية في عيون المجتمع. فمتى يمكننا أن نتخلى عن هذا التعلق بالمسميات، ونتجه نحو تقدير الكفاءة والإنجاز بذاته، أسوة بالعديد من المجتمعات الأخرى التي تجاوزت هذه المرحلة؟
بحثتُ حتى أتعمق وأفهم أكثر عن سيطرة هذا السلوك علينا. ووجدت إن ميل المجتمعات العربية لـ "تقديس التايتل" ينبع من عدة عوامل متجذرة في بنيتها الثقافية والاجتماعية، تختلف عن تلك السائدة في المجتمعات الغربية. ففي مجتمعاتنا، يسود قبول واسع للتسلسل الهرمي والسلطة (المسافة السلطوية العالية)، وتعمل الألقاب على ترسيخ هذا التسلسل، مانحة حاملها مكانة خاصة واحترامًا مبالغًا فيه. يُنظر إلى الدكتور أو المهندس ليس فقط كخبراء في مجالاتهم، بل كأشخاص يمتلكون سلطة معرفية واجتماعية تستدعي التبجيل. على النقيض تمامًا، تميل المجتمعات الغربية إلى مسافة سلطوية منخفضة، حيث تُفضل العلاقات الأكثر مساواة ويُقلل من التركيز على الألقاب في التعاملات اليومية، وغالبًا ما يُكتفى بالاسم الأول.
علاوة على ذلك، تتميز مجتمعاتنا العربية بكونها غالبًا جماعية، حيث يُنظر إلى نجاح الفرد، بما في ذلك حصوله على لقب مرموق، كنجاح للعائلة بأكملها، مما يعزز مكانتها وشرفها. هذا يختلف عن المجتمعات الغربية، وخاصة الفردية منها، التي تركز على الإنجازات الفردية والاستقلالية، ويُقدر فيها ما ينجزه الفرد ومهاراته أكثر من مجرد المسمى الوظيفي. يرتبط هذا التوجه أيضًا بطريقة التقييم المجتمعي؛ فالمجتمعات العربية غالبًا ما تميل إلى التقييم القائم على الإسناد، حيث تُمنح المكانة بناءً على "من أنت" (نسبك، عائلتك، لقبك) وليس بالضرورة على "ماذا تنجز". اللقب في هذه الحالة هو علامة على هذه المكانة المُسندة. في المقابل، تركز المجتمعات الغربية بشكل أكبر على التقييم القائم على الإنجاز، حيث تُمنح المكانة بناءً على ما يفعله الفرد ويساهم به، وتُكتسب الألقاب المهنية من خلال تحقيق إنجازات ملموسة ومساهمات فعلية.
تاريخيًا، ارتبطت الألقاب بالوجاهة والنفوذ في مجتمعاتنا، مما جعل الحصول على لقب مرموق لا يوفر تقديرًا اجتماعيًا فحسب، بل يُعد أيضًا ضمانة نسبية لـ الأمان الوظيفي والاستقرار المالي في بيئات اقتصادية قد تكون متقلبة. كما تلعب التوقعات المجتمعية دورًا كبيرًا؛ فالأسر غالبًا ما تدفع أبناءها نحو مسارات مهنية معينة لضمان حصولهم على ألقاب مرموقة، مما يضع ضغطًا عليهم للسعي وراء هذه الألقاب كطريق لتحقيق الرضا الأسري والمجتمعي، حتى لو لم يكن ذلك يتناسب بالضرورة مع شغفهم الحقيقي.
إن التخلي عن هذا "التقديس" ليس مجرد قرار فردي، بل هو تحول ثقافي عميق يتطلب وقتًا وجهدًا. سيبدأ هذا التغيير عندما يصبح التركيز على الإنجاز الفعلي، الابتكار، والتأثير الإيجابي، والمهارات الحقيقية هو المعيار الأساسي للنجاح والتقدير، بدلًا من مجرد المسمى الوظيفي. وعندما تُقدّر الكفاءة بذاتها، بغض النظر عن الألقاب، سنكون قد خطونا خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر نضجًا وإنصافًا، حيث الجوهر أهم من المظهر. ربما تحتاج أجيالنا القادمة إلى التحرر من هذا العبء الثقافي لتتمكن من تحقيق إمكاناتها الكاملة دون قيود المسميات.


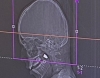




 هاي فايف
هاي فايف